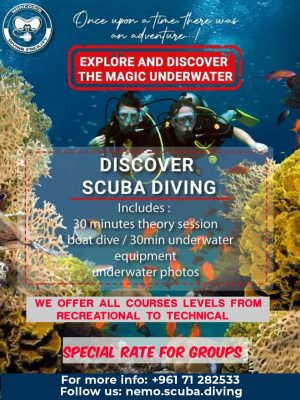قدم للقارىء العربي واحداً من أهم أعمال فريدريك إنجلز، والأعمال الماركسية الكلاسيكية العامة، هو ديالكتيك الطبيعة. ففي هذا المؤلف يتصدى إنجلز للإيديولوجية البورجوازية التي حاول ممثلوها استخدام معطيات العلوم الطبيعية لـ “دحض” الماركسية وأساسها الفلسفي – المادية الديالكتية، وعملوا لإشاعة الأمزجة المثالية واللاأدرية والذاتية في أوساط العلماء، ويقوم بترسيخ مواقع المادية الديالكتيكية في علوم الطبيعة وبتعميم العلوم المعاصرة له من زاوية الديالكتيك المادي، ويبين أن المادية الديالكتيكية هي الرؤية العلمية الوحيدة التي تعتمد على العلم اعتماداً كلياً وتجد فيه ميداناً لإثبات صحتها، وأن معطيات العلوم الطبيعية، بدورها، لا يمكن أن تلقى التفسير والتعميم النظري الصحيح إلا في ضوء الديالكتيك المادي.
كان اهتمام إنجلز بمشكلات العلوم الطبيعية قد بدأ منذ الأربعينيات من القرن التاسع عشر. ولكن هذا الاهتمام كان ثانوياً في البداية، استدعته، بصورة رئيسية، دراسة إنجلز النقدية لـ فلسفة الطبيعة الهيغلية وعمله في ميدان الاقتصاد السياسي.
وفي أوائل الخمسينيات اتجه إنجلز، الذي كان يقيم في مانشستر آنذاك، نحو دراسة الفيزيولوجيا. وفي أواخر هذا العقد إطّلع على الاكتشافين الكبيرين اللذين توصلت إليهما علوم الطبيعة في الثلاثينيات والأربعينيات: النظرية الخلوية (التي وضعها شيلدن وشفان عامي 1838 و 1839 ) ونظرية حفظ الطاقة وتحولها (التي صاغها ماير وآخرون ما بين عامي 1842 و 1847) ، فشرع بتعميمهما الفلسفي من مواقع الديالكتيك. ففي رسالة له إلى ماركس (بتاريخ 14/ 7/ 1858) يطلب منه إرسال كتاب هيغل فلسفة الطبيعة، ويعبر عن رغبته في التحقق مما إذا كان هيغل قد استبق شيئاً من هذين الاكتشافين اللذين تما بعد وفاته، ويرى في النظريتين المذكورتين تجسيداً لبعض موضوعات الديالكتيك الهيغلي وإثباتاً علمياً وقائعياً لها.
وفي هذه الرسالة لا يشير إنجلز إلى عزمه على كتابة مؤلف، مكرس للتعميم الفلسفي للاكتشافات الجديدة في علوم الطبيعة، ولكن يلوح من سياق النص كله سعيه لتقديم تأويل مادي للديالكتيك (للمنطق) الهيغلي ولفلسفة الطبيعة الهيغلية على أساس التحليل الفلسفي لأحدث الإنجازات العلمية.
وفي عام 1859 صدر مؤلف داروين أصل الأنواع، الذي يمثل ثالث الاكتشافات العظمى في علوم الطبيعة في القرن التاسع عشر– نظرية النشوء والارتقاء، والذي قدره إنجلز وماركس عالي التقدير. وفي الستينيات تابع إنجلز تعمقه في سبر أغوار مذهب تحول الطاقة، حيث راح يرى فيه، مجدداً، إثباتاً للأفكار الهيغلية. وفي هذا العقد نفسه تعرف، بفضل العالم الشيوعي الألماني كارل شورلمر، على منجزات الكيمياء، وخاصة الكيمياء العضوية، وعلى نجاحات النظرية الذرية الكيميائية.
وإذا كان توجه إنجلز (وماركس) نحو العلوم الطبيعية في الخمسينيات والستينيات يعود إلى الرغبة في إرساء الرؤية المادية الدياكتيكية على أرضية متينة وراسخة، فإن تطور العلوم الطبيعية نفسها في السبعينيات والثمانينيات كان يطرح ضرورة التعميم النظري والتحليل الفلسفي لمنجزات العلم.
ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهدت علوم الطبيعة تطوراً سريعاً وعاصفاً، ففضلاً عن الاكتشافات الثورية الثلاثة المذكورة أعلاه، اُحرزت نجاحات كبيرة في ميادين الرياضيات والفلك والكهرباء والمغناطيسية (ولا سيما وضع ماكسويل للنظرية الكهرطيسية في الضوء). وكان للجدول الدوري، الذي وضعه مينديلييف والذي أرسى أساس نظرية بنية المادة، أثر بعيد في دفع الفيزياء والكيمياء إلى الأمام. وظهرت معطيات جديدة في علوم الفيزيولوجيا (على يدي هاكسلي وهايكل وباستور) والباليونتولوجيا (علم المستحاثات) والأمبريولوجيا (علم الأجنّة).
وكان لا بد لإنجازات العلوم الطبيعية من أن تعكس على طابع التفكير العلمي وبنيته. ففي تلك السنوات كانت السمة المميزة لعلوم الطبيعة هي أن كل علم منها كان يتعمق بمفرده في الكشف عن جوهر الطبيعة المادي الديالكتيكي. وكانت العلوم الطبيعية، بمسيرتها ومضمونها، تبين الانتقالات والارتباطات بين مختلف ميادين الكون. ولكن أسلوب التفكير الميتافيزيقي (غير الديالكتيكي)، الذي كان يسود في علوم الطبيعة، غدا عائقاً جدياً على طريق تطورها. فقد راح تطور العلوم يكشف عن التناقضات بين المعطيات العلمية المتجمعة وبين طريقة التفكير الميتافيزيقية. وكان استجلاء القوانين الأساسية للطبيعة، وصياغة النظريات العامة الشاملة، يمهدان، بصورة عفوية، لطرد الميتافيزيقيا من علوم الطبيعة، ويتطلبان، بإلحاح متزايد، منهجاً جديداً في التفكير.
وبمثابة رد على الميتافيزيقيا السابقة، التي صارت عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات العلوم الطبيعية والتي كانت في نظر الكثير من العلماء مرادفاً لكل فلسفة، تكوّن في الأوساط العلمية انطباع بأن العلم لا يحتاج إلى أي تعميم فلسفي. وتبلور هذا التوجه في المذهب الوضعي (Positivism)، الذي صادف رواجاً واسعاً في العلوم الطبيعية. وقد لاقت موضة الوضعية، كلون من الفلسفة الرجعية، انتشاراً كبيراً في ألمانيا، مما انعكس في كتابات دوهرينغ، الذي سيكرس إنجلز لنقده كتابه المعروف أنتي دوهرينغ.
وبعد كومونة باريس (1871) تفاقمت حدة الصراع بين البورجوازية والبروليتاريا. وقد انعكس هذا الصراع في العلوم الطبيعية أيضاً. فراح منظرو البورجوازية يستخدمون الصعوبات التي تعاني منها العلوم بهدف إحياء المذاهب المثالية القديمة، ويعملون على توظيف العلوم الطبيعية لدحض المادية الديالكتيكية بوصفها الأساس الفلسفي للماركسية، ويشوهون مضمون الإنجازات العلمية، ويؤولونها بروح النزعة النسبية (القول أن المعارف نسبية كلها، لا تحتوي على أي عنصر مطلق، وبالتالي لا وجود لحقيقة موضوعية) واللاأدرية (القائلة بأن الكون، أو بعض ظواهره، متعذر إطلاقاً على المعرفة البشرية) والصوفية وغيرها.
وإلى جانب اللاهوت الرسمي، الذي كان يفرض احترامه، إلى هذا الحد أو ذاك، على الكثير من العلماء، شهدت أوساط المجتمع البورجوازي المثقف، في السبعينيات، ألواناً من الخزعبلات، مثل الإيمان بالأرواح واستحضارها (أوليس، كروكس، زولنر، وغيرهم).
وفي تلك الفترة راجت “الداروينية الاجتماعية”، التي كان أنصارها ينكرون وجود قوانين موضوعية تحكم التطور الاجتماعي، ويزعمون أن المجتمع البشري يتطور وفقاً لقوانين بيولوجية محضة: ففي المجتمع البشري، كما في عالم الحيوان والنبات، يجري صراع مستمر من أجل البقاء؛ ولذا فإن استغلال الإنسان هو عملية طبيعية، تنبع من طبيعة الإنسان نفسها.
وشهدت اللاأدرية بعثاً جديداً في الأوساط العلمية. فقد استخدمت المعطيات الجديدة في الفيزيولوجيا، لا سيما فيزيولوجيا الحواس، من أجل الزعم بتعذر معرفة الطبيعة. وفي ألمانيا ظهرت مدرسة كاملة من “المثالية الفيزيولوجية”، يقف على رأسها العالمان الكبيران ميولر وهلمهولتز، صاحبا نظرية “حدود المعرفة”.
وراجت بين الفيزيائيين نظرية “الموت الحراري للكون”. وصار عدد من العلماء ينظرون إلى الرياضيات نظرة ذاتية، فيصورونها إبداعاً محضاً للفكر، خلواً من أي مضمون واقعي موضوعي.
وكانت ألمانيا، خاصة، مسرحاً لهذه التوجهات والمذاهب. وكان هناك عدد كبير من الانتقائيين والتحريفيين والمقلدين، الذين يطرحون آراءهم على أنها الآراء الوحيدة التي تنسجم كلياً مع العلوم الطبيعية.
وبين هؤلاء المفكرين كان المادي العامي (Vulgar) بوخنر، الذي كان يتنطع أيضاً إلى حل المسائل التي طرحتها النظرية الاشتراكية. وفي أواخر عام 1872 صدرت الطبعة الثانية من كتاب بوخنر الإنسان ومكانه في الطبيعة. وقد وصلتنا نسخة من هذا الكتاب، دوّن إنجلز بعض الملاحظات على هوامش صفحاتها. وفي ضوء هذه الملاحظات يتبين أن الشيء الرئيسي، الذي لفت انتباه إنجلز، هو آراء بوخنر، التي تسمح بتصنيفه في عداد أنصار الداروينية الاجتماعية، التي كانت، طيلة الستينيات، موضع انتقاد ماركس وإنجلز.
وأغلب الظن أنه في مطلع عام 1873 اعتزم إنجلز على التصدي لبوخنر على صفحات المطبوعات الدورية. وكان بإمكان هذا العزم أن يتحقق في صورة مقالة، أو سلسلة مقالات، في صحيفة فولكستات الناطقة بلسان حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الألماني. ففي هذه الصحيفة بالذات نشر إنجلز أنتي دوهرينغ. وكان من المقدر للبحث الجديد أن يأتي على نحو مماثل – في صورة أنتي بوخنر.
وفي مستهل مخطوطة ديالكتيك الطبيعة ثمة نبذة، عنوانها بوخنر، هي أشبه بملخص لمعارضة بوخنر المرتقبة.
وقد حرر القسم الأساسي من هذه النبذة قبل الثلاثين من أيار/ مايو عام 1873 (قبل اليوم الذي ظهر فيه عزم إنجلز على وضع ديالكتيك الطبيعة). وينطلق إنجلز هنا من كتاب بوخنر الآنف الذكر. ولكن إذا كانت ملاحظاته على هوامش الكتاب تعكس، بصورة رئيسية، الموقف النقدي من الداروينية الاجتماعية، فإن إنجلز يركز اهتمامه الآن على نقد المادية العامية، ويعنى بالدفاع عن الديالكتيك. وبصياغة الفهم المادي للطبيعة. ويرسم إنجلز في نبذته هذه مهمتين رئيسيتين للنضال ضد الماديين العاميين: 1- التصدي للإساءة إلى الفلسفة؛ 2- التصدي لمحاولات سحب النظريات الخاصة بالطبيعة وتعميمها على المجتمع، ولمحاولات “إصلاح” الاشتراكية وكان تضاد الديالكتيك والميتافيزيقيا يمثل الفكرة المحورية لـ أنتي بوخنر المرتقب. ولكن وضع بحث كهذا لم يكن من السهل، طالما لم يتوضح، بعد، الأساس العلمي – الطبيعي الذي يجب أن يستند إليه. صحيح أنه كان بوسع إنجلز الاعتماد على موضوعة وحدة الطبيعة وارتباطها الشامل وتطورها، وهي الموضوعة التي أثبتتها اكتشافات العلوم المعاصرة لإنجلز، فقد بينت النظرية الخلوية وحدة بنية وأصل العالم العضوي كله – الفرطيسات والنباتات والحيوانات، وربطت الداروينية بين كافة أشكال العالم العضوي، وكشفت نظرية تحول الطاقة عن الصلة الداخلية بين العلوم التي تدرس مختلف أشكال الطاقة في الطبيعة غير الحية، وهكذا تم الوقوف على الرابطة التي تجمع بين أشكال الطاقة في الطبيعة غير الحية، وعلى ارتباط أشكال العالم العضوي في الطبيعة الحية. ولكن هذين الميدانين الأساسيين – الطبيعة الجامدة والحية – بقيا منعزلين أحدهما عن الآخر، فلم يكن العلماء قد أفلحوا بعد في رصد ارتباطهما. وبذلك كان من المتعذر رسم لوحة كاملة عن الارتباط الشامل لظواهر الطبيعة، الأمر الذي كان يحول دون وضع مخطط دقيق لـ أنتي بوخنر، ودون توجيه العمل فيه بالمنحى المطلوب.
وفي الثلاثين من أيار / مايو 1873 توصل إنجلز إلى اكتشاف هام، يزيل العوائق التي كانت تعترض طريقه في البحث المنشود، إذا وجد الأداة التي تساعد على ردم الهوة، التي كانت لا تزال قائمة بين الطبيعة الجامدة والحية: فكرة التطور العامة.
ففي إطار العلوم الجزئية (الفلك والفيزياء والكيمياء والجيولوجيا والبيولوجيا) كانت فكرة التطور قد رسخت مواقعها إلى ذلك الحين. ولكن بالنسبة لعلوم الطبيعة ككل، ولا سيما بالنسبة للميادين الواقعة على تخوم علوم الطبيعة العضوية وغير العضوية ، لم تكن قد رسمت بعد لوحة شاملة لتطور الطبيعة، فبقيت ثغرة كبيرة، لا بد من سدها، وقد جاء اكتشاف إنجلز ليملأ – من حيث المبدأ، على الأقل – هذا الفراغ.
بدأ إنجلز بصيلغة مفهوم، أوسع بكثير من المفاهيم التي كان العلماء يتعاملون بها حتى الآن، هو “شكل الحركة”، الذي ينطوي على مفهوم أشكال الطاقة (الميكانيكية، والفيزيائية والكيميائية) وعلى مفهوم العملية البيولوجية. وبمساعدة هذا المفهوم يحاول إنجلز تتبع كيفية تحول أشكال الحركة، الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية، أحدها إلى الآخر، ويدرس – وهذا هو الأهم – كيفية ظهور الحياة. وبذلك استجليت حقيقة وجود عملية تطور ديالكتيكية موحدة، تتخلل الطبيعة كلها، وتربط بين مختلف مجالاتها في نسق معين.
وكان هذا الاكتشاف يتجاوز الإطار الضيق لـ أنتي بوخنر ، وينطوي على قيمة مستقلة بحد ذاته، ويمهد الطريق لمعالجة المسائل الجذرية لديالكتيك العلوم الطبيعية. وقد صاغ إنجلز اكتشافه في رسالته إلى ماركس في 30 أيار/مايو 1873، التي يبسط فيها عزمه على تطبيق المنهج الديالكتيكي (منهج الارتقاء من المجرد إلى العياني) في القسم الأساسي من العلوم الطبيعية غير العضوية – الميكانيك والفيزياء والكيمياء، بما في ذلك خروج عملية التطور عن حدود الكيمياء، وانتقالها إلى ميدان الطبيعة العضوية (الحياة) . ومنذ ذلك الحين بدأ، في حقيقة الأمر، عمل إنجلز في ديالكتيك الطبيعة المقبل.
وقد سار العمل على النحو التالي. منذ أيار/ مايو 1873 وحتى أيار/مايو 1876 انهمك إنجلز في الإعداد لمؤلفه، فجمع المواد اللازمة، وبدأ بكتابة الفصول الأولى (مقدمة تاريخية). ولكن منذ أيار/مايو 1873 وحتى أيار/مايو 1876 إنصرف إنجلز نهائياً لوضع أنتي دوهرينغ، وبذلك انقطع عامين كاملين عن العمل في ديالكتيك الطبيعة. ومنذ الانتهاء من أنتي دوهرينغ وحتى وفاة ماركس (تموز/يوليو 1878 – آذار/مارس 1883) عاد إنجلز للاشتغال بمؤلفه المنتظر. ولكن وفاة ماركس جعلته يتوقف عن العمل المنتظم فيه، ويوجه معظم قواه وجلّ وقته لإنجاز المجلدين الثاني والثالث من رأس المال، اللذين تركهما ماركس غير مكتملين.
بيد أنه حتى بعد آذار/مارس 1883 كان إنجلز يعود إلى مؤلفه بين الحين والآخر. ولكنه لم يعد يكتب له فصولاً أو نبذات جديدة، خاصة به، بل راح يضم إليه ما بقي دون نشر من أعماله الأخرى. فقد أضاف إليه المقدمة القديمة لـ أنتي دوهرينغ (المكتوبة عام 1878) وملاحظات ثلاث، كانت معدة أصلاً للطبعة الثانية من أنتي دوهرينغ (التوافق بين الفكر والوجود – اللامتناهي في الرياضيات، الأشكال المختلفة للحركة والعلوم التي تدرسها، ناغيلي)، والمحذوف من فيورباخ ، ومقالة دور العمل في تحول القرد إلى إنسان (وكانت قد كتبت ، أول الأمر، لعمل آخر) . ويبدو أن إنجلز لم يفقد الأمل في أنه سيعود إلى كتابه بعد الفروغ من إعداد المجلدين الثاني والثالث من رأس المال للطبع، لينهيه، مستخدماً في ذلك بعض المواد من أبحاثه الأخرى.
وعلى مشارف التسعينيات، عندما كان العمل في المجلد الثالث من رأس المال يشارف على نهايته، بدأ إنجلز يحضر لنشر مخطوطة ديالكتيك الطبيعة. فقد فصل المواد، الجاهزة إلى حد ما، عن باقي المواد غير الجاهزة وعن الملاحظات الصغيرة التي قارب عددها المئتين. ووزع إنجلز هذه المواد إلى أربع مجموعات، كل منها في مصنف مستقل.
فقبل كل شيء فرز إنجلز اثنتي عشرة مقالة، جاهزة إلى هذا الحد أو ذاك، وأدرجها في مصنفين (ست مقالات لكل منهما). وفي أحد المصنفين (الثاني بين المصنفات الأربعة، حسب ترتيب إنجلز) أدرجت المقالات التي كان إنجلز قد كتبها أصلاً لأعمال أخرى – ملاحظاته المتعلقة بالطبعة الثانية من أنتي دوهرينغ، والمقدمة القديمة لهذا الأخير، والمحذوف من فيورباخ، ودور العمل في تحول القرد إلى إنسان. وفي المصنف الأخير (الثالث، حسب ترتيب إنجلز) أدرجت الفصول المكتوبة خصيصاً لـ ديالكتيك الطبيعة وفقاً لـ المخطط الجزئي، بالإضافة إلى مقالة العلوم الطبيعية في عالم الأرواح التي ألحقت بالمصنف في وقت متأخر. أما المقتطفات والملاحظات غير الجاهزة وغير المدروسة فقد وزعت بين المصنفين الباقيين. ففي الأول جمع 130 مقتطفاً، بينها نبذات كبيرة نسبياً، مثل الصدفة والضرورة. وفي المصنف الأخير، الرابع، أدرج 43 مقتطفاً، منها فصلان غير مكتملين – الديالكتيك والحرارة. وفي آخر المصنف الرابع أدرج مخطط ديالكتيك الطبيعة – المخطط العام، الذي جاء بمثابة فهرس الكتاب. وفي ضوء هذا يمكن القول أن إنجلز كان يستعد لاختتام عمله في ديالكتيك الطبيعة. ولكن عزمه هذا بقي دون تحقيق ، إذ عاجلته المنية في الخامس من آب/أغسطس 1895.
في حياة إنجلز لم تنشر أي من المواد المدرجة في ديالكتيك الطبيعة. وبقيت المخطوطة محفوظة في أرشيف الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني طوال الثلاثين عاماً التي أعقبت وفاة إنجلز. ولم تر النور في تلك الفترة إلا مقالتان من المؤلف، هما دور العمل في تحول القرد إلى إنسان (نشرت عام 1896 في “Neue Zeit”) والعلوم الطبيعية في عالم الأرواح (صدرت عام 1898 في “Illustriter Neue welt Kalender”). وفي عام 1925 صدرت في الاتحاد السوفياتي الطبعة الأولى من ديالكتيك الطبيعة،وذلك في الكتاب الثاني من أرشيف ماركس وإنجلز، حيث وضع النص الألماني إلى جانب الترجمة الروسية. وفي هذه الطبعة رتبت مواد الكتاب تقريباً بنفس الترتيب الذي وصلتنا فيه، أي تبعاً لتوزيع المواد بين المصنفات الأربعة، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة. ولكن قراءة الكتاب في صورته هذه كانت صعبة للغاية، لأن إنجلز رتّبه على النحو المذكور بهدف متابعة العمل فيه وإنجازه، أي لم يرتبه حسب الموضوعات، بل تبعاً لدرجة اكتمال العمل فيها.
وبعد عقد من الزمن صدرت طبعة جديدة من ديالكتيك الطبيعة (عام 1935) بالألمانية، وبعدها بخمس سنوات ظهرت ترجمة إنكليزية (عن الألمانية) ، أشرف عليها العالم الماركسي الإنكليزي جـ. هولدين. ومن مزايا هاتين الطبعتين أن المواد، الجاهزة إلى حد ما، وضعت في أول الكتاب، بينما نقلت النبذات والملاحظات الصغيرة والمسودات إلى آخره. هذا فضلاً عن أن هولدين زوّد الطبعة الإنطليزية بملاحظات قيمة، وكتب مقدمة له.
وفي العام نفسه – عام 1940 – بدأ العمل لإصدار الطبعة الروسية الثانية، استناداً إلى خبرة الطبعتين الألملنية والإنكليزية. وقد نقحت الطبعة الجديدة (1941) من الأخطاء ومواضع عدم الدقة التي لوحظت في الترجمة السابقة من الألمانية إلى الروسية. ولكن المهم فيها هو أن ترتيب المواد تم – عموماً – وفقاً لموضوعاتها، وجرى بالاستناد إلى المخطط العام. وفي هذه الطبعة وزع الكتاب إلى قسمين، روعي في إطار كل منهما الترتيب المذكور: 1- مقالات وفصول، حيث تندرج المواد الكبيرة والجاهزة نسبياً؛ و 2- ملاحظات ومقتطفات، حيث المواد الصغيرة وغير الجاهزة أو غير المدروسة.