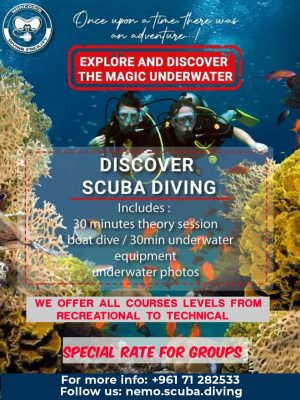علامات انهيار «المعادلة» الأميركيّة ــ السعوديّة
«مثل فيل ضخم يقبع في الغرفة وتحاول الولايات المتحدة ألّا تراه»، هو تشبيه أميركي للعلاقة غير السليمة بين أمبراطورية الديموقراطية ومملكة آل سعود. فماذا لو تزعزعت فعلاً علاقة الولايات المتحدة بأقدم حليف عربي لها؟ سؤال يؤرّق المملكة السعودية، ويحيّر إدارة أوباما ويُرعب إسرائيل
«مناعة» هي الكلمة التي كانت تظهر عند ذكر المملكة العربية السعودية في سياق الحديث عن الثورات العربية والتغيير الحاصل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المتابعون الأميركيون ،خصوصاً، تكلموا على «مناعة» تتمتع بها المملكة من شأنها أن تجنّبها الانضمام الى نادي الأنظمة المخلوعة أو المرشّحة للخلع. ومع وصول التحركات الى البحرين واليمن والأردن وعُمان، اتجهت الأنظار تلقائياً الى الجارة السعودية، فجاءت «التطمينات» الإميركية إلى أن المملكة قوية: «قطوع» الاحتجاجات المحدودة فيها مرّ بـ«سلام» سياسي وإعلامي، والتدخّل العسكري المباشر في البحرين حظي بشجب خجول وعابر.
ولكن في الأسابيع الأخيرة الماضية، تغيّر المشهد التحليلي. لم تقتصر الأخبار الأميركية الآتية من المملكة على أسعار النفط والغاز الطبيعي، أو على شؤون تأثر البورصة النفطية بالتغيرات السياسية والأحداث الأمنية. فالأميركيون يعلمون أن ما يجري في قصور آل سعود الآن هو ما سيرسم شكل المنطقة ويحدد المراحل الحاسمة التي ستشهدها في المستقبل القريب.
لذا كان لا بد من أن يتحدث عارفون بأحوال المملكة عن بعض مشاكلها، وبعض ما يشوب العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية وأقدم حليف عربي لها، من دون أن يغضبوها أو يحرّضوا على نظامها، أو ينتقدوا حكّامها مباشرة.
«العلاقات الأميركية ـــــ السعودية تدهورت بعدما شعرت المملكة بأن الولايات المتحدة لا تستطيع حماية حلفائها في المنطقة»، هذه هي الفكرة الموحدة عند معظم المراقبين الأميركيين. هؤلاء يقولون إنه بعدما فشلت كل المساعي، والضغوط السعودية لمنع إسقاط نظام الرئيس المصري حسني مبارك، وبعدما انتقدت الإدارة الأميركية تدخل السعودية في البحرين (ولو بطريقة عابرة) وبعد التأخر في حسم الوضع في اليمن، أدرك آل سعود أنه لا يمكن الوثوق بإدارة باراك أوباما. «نيويورك تايمز» تحدّثت عن آخر اتصال هاتفي بين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس أوباما خلال الثورة المصرية وقالت إنه انتهى «بخلاف حاد».
من هنا وصف البعض موقف الرئيس الأميركي بـ«الصعب»، إذ إنه أمام «تحدّ كبير». وهذا التحدي يتمثل في أن يستطيع أوباما وإدارته التوفيق بين دعم الثورات والتغيرات التاريخية الحاصلة والمحافظة على علاقات ممتازة مع «أقدم وأغنى حليف عربي للأميركيين، والأكثر تأثيراً في المنطقة». طبعاً، صعوبة موقف أوباما تتمثل أيضاً بالأثر الكارثي الذي ستسببه أي قطيعة مع النظام السعودي على أسعار النفط، وبالتالي على الاقتصاد الأميركي الذي لم يتعاف بعد… وعلى كل آمال إعادة انتخاب أوباما رئيساً للبلاد. فهل يكون إيفاد مستشار الأمن القومي في الإدارة الأميركية، توماس دونيلون، الى الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية أول من أمس، محاولة لاستعادة «المسار الطبيعي» للعلاقات إذا كان شبح القطيعة يلوح جدّياً في الأفق؟
قلق ولجوء إلى الأصدقاء القدامى
القلق السعودي وقلّة الثقة بالأداء الأميركي يرجعهما البعض الى ما قبل سقوط الأنظمة السنيّة الحليفة للسعودية في المنطقة، فهما يعودان في نظرهم الى الغضب السعودي من «رمي العراق في الحضن الإيراني» بعد كل الجهود التي بذلتها السعودية لكسب المعركة هناك.
«سبق للسعوديين أن شاهدوا الفيلم الأميركي ذاته» يقول بروس رايدل في «ناشيونال إنترست»، ويذكّر أنه «عام 1978 شهدت المملكة كيف تخلّى جيمي كارتر عن شاه إيران، وكيف حلّت ثورة إسلامية شيعية محله». لذا، قرّرت المملكة أن «تتجاهل» الولايات المتحدة وتوقف التواصل معها، وتوصي سائر الممالك العربية بفعل الأمر نفسه، تضيف «ناشيونال إنترست». وهذا «التجاهل» ترجمه البعض بقرار تدخّل المملكة عسكرياً في البحرين، وهو ما عُدّ «رسالة من النظام السعودي الى العراق وإيران بعدم التدخل في شؤون الجزيرة، ولأوباما بأن لا يدعم ثورات الباحة الخلفية للمملكة».
قلق آخر «يؤرّق الملك السعودي»، وهو ما تحدّث عنه روبرت دريفوس في مجلة «ذي نايشن»: إنه صعود الدور المصري ـــــ الذي حاولت السعودية كبحه طوال الفترة السابقة ـــــ والاتجاه إلى تكوين قوة إقليمية جديدة وفاعلة، قد لا تتفق مع كل السياسات والخطط السعودية للمنطقة.
بعض المراقبين أشاروا إلى لجوء السعودية ل«أصدقائها القدامى»، مثل باكستان والصين، اللتين تقدمان دعماً بالسلاح والعسكر والاستخبارات والمال، بدلاً من الولايات المتحدة في حال حصول أزمة داخلية. ويضع البعض زيارة بندر بن سلطان لإسلام أباد الشهر الماضي في إطار اتفاق على الاستعانة بقوات باكستانية خاصة لردع أي تحركات داخلية في المملكة ومواجهتها.
بعض الاستراتيجيين اقترحوا إمكان تحالف سعودي ـــــ إسرائيلي لتأليف جبهة قوية في المنطقة بغية «قطع رأس الأفعى» (إيران)، ولكي تحمي المملكة وجودها ومصالحها، بعدما باتت تشكّ بقدرة الولايات المتحدة على ذلك.
مارتن إنديك يذكّر في الـ«واشنطن بوست» بأنه في فترة الأزمات لطالما اعتمد ملوك السعودية على الرؤساء الأميركيين للحفاظ على أمنهم الخارجي. «لكن الملك عبد الله، في الأزمة الحالية، يرى في أوباما تهديداً لأمن المملكة الداخلي». إنديك يحذّر الإدراة الأميركية من تداعيات ترك السعودية تنفّذ سياستها في المنطقة كما تريد، ما «سيجرّ الى صراع سني ـــــ شيعي أكيد، وبالتالي صراع عربي ـــــ إيراني فصراع عربي ـــــ إسرائيلي»، وهو ما سينهي معادلة السلام الأميركية في المنطقة. لذلك كلّه يستعجل إنديك أوباما لـ«إبرام اتفاق جديد مع الملك السعودي، وإقناعه بأن الحل الوحيد لحماية مملكته ومصالحه هو انتشار أنظمة ملكية دستورية في السعودية وفي الدول المحيطة بها». طبعاً، مع تقديم تطمينات أميركية للملك إلى أن حليفته الغربية القديمة لن تعقد أبداً أي اتفاق مع أعدائه الإيرانيين على حسابه.
انهيار المعادلة الأميركية ـ السعودية؟
ولكن إلى أي مدى ستنجح الإدارة الأميركية بالاحتفال بالحريات، وتثبيت حقوق الإنسان، ودعم الديموقراطيات في الشرق الاوسط المتغيّر، وغضّ النظر عن ارتكابات النظام السعودي المخالفة لكل تلك المبادئ؟ هكذا يتساءل معظم المتابعين الأميركيين لشؤون المنطقة، لكن الردّ جاء مدوياً من بعض المحللين الذين صعّدوا لهجة انتقاداتهم للمملكة وللعلاقات السعودية ـــــ الأميركية. هؤلاء أجابوا بأن للولايات المتحدة مصالح تتقدم أحياناً على مبادئها في الأولويات، وخصوصاً في ما يتعلق بالمملكة السعودية.
روبرت شير كتب في مجلة «ذي نايشن» الأسبوعية أن «الذهب الأسود» هو ما يجعل الدول الأوروبية والولايات المتحدة «لا تبالي فعلاً بحقوق الإنسان التي تستخدمها ذريعة لتدخلاتها العسكرية في المنطقة»، ولو كانت تهتمّ بالحريات والمساواة فلماذا لا تطالب بذلك للمواطنين الشيعة الذين يعيشون في المنطقة النفطية في السعودية، والذين يحرمون الحقوق التي يتمتّع بها سائر المواطنين؟ لماذا لا ينسحب حق تقرير الشعوب لمصيرها على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة؟ يسأل شير في مقاله. ويضيف أن التضليل الحاصل هو في التركيز على أن إيران الشيعية هي مركز الإرهاب، «بينما الكل يعرف أن السعودية هي الدولة التي ساهمت بصعود تنظيم القاعدة، وأن من بين منفّذي هجمات 11 أيلول التسعة عشر هناك خمسة عشر من أصل سعودي وإماراتي». ويختم شير مستغرباً كيف أن «قمع السعودية لشعوبها ولشعب البحرين حُسبا ضمن الحدود المعقولة لدى الولايات المتحدة والحكومات الغربية».
بعض المراقبين يؤكدون استحالة استمرار المعادلة الأميركية المعتمدة تجاه السعودية منذ عشرات السنين كما هي. ستيفين ليفين، في مجلة «فورين بوليسي»، يشير الى أنه «لم يعد بالإمكان الاعتماد على بقاء الأمراء السعوديين في مناصبهم أو في سدة الحكم لفترة طويلة كما في السابق».
صحيفة «بوسطن غلوب» لفتت الى أن معادلة النفط السعودي مقابل الحماية الاميركية التي ترسخت منذ 1945 «تتجه الى الانهيار»، لأن السعودية لم تعد تضمن الحماية الاميركية لها ولمصالحها. «القلق ذاته يخالج إسرائيل»، تنبّه الصحيفة.
إضافة الى كل الأوضاع الإقليمية والدولية وتوتر العلاقات، يتطرق البعض الى ما وصفوه بـ«هشاشة» الحكم ضمن العائلة المالكة السعودية التي تعاني مشكلة تقدّم أولياء العهد في السن، وأخرى متصلة بالتحالفات المتشعبة وعدم الاستقرار مع رجال الدين الوهابيين في المملكة، دون إغفال نسبة البطالة المرتفعة بين الشباب السعودي، التي ستخلق مشاكل اجتماعية عديدة في المستقبل القريب.
ولكن، في خضمّ القلق المتبادل بين السياسيين ورجال الاعمال والملوك والرؤساء، يبرز رأي «مهدّئ» يقول إنه في كل أزمة عربية أو تغيير في الشرق الأوسط تكثر التكهنات حول زعزعة الحكم في المملكة، من دون الانتباه الى واقع كون السعودية هي إحدى أكثر الدول تأثيراً في أمن المنطقة واستقرارها كما في الميزان الاقتصادي العالمي… ذلك هو سبب «المناعة»، وهنا مصدر «القلق».
بطء الإصلاح
لم يتردّد بعض المحللين الأميركيين في التذكير بتاريخ العلاقات مع المملكة، وتحديداً بما كانت عليه السعودية قبل التعرّف إلى حليفتها الأميركية، كالإشارة، مثلاً، الى أنه لم يكن في الرياض طرقات معبّدة ولا مبان ولا بنى تحتية الى حين تنفيذ الشركات الأميركية المشاريع الحيوية تلك. ويروي آخرون أنه عندما وصل الهاتف الى السعودية خاف منه المتدينون وطالبوا بمنعه. لكن الملك السعودي (الملك عبد العزيز) جمع رجال الدين في قصره، وعندما رنّ الهاتف في الغرفة، وضع مكبّر الصوت وخرج منه صوت الأذان، فارتاح الشيوخ وسمح بالهواتف. كذلك يشير البعض الى البطء المعروف عن الملوك السعوديين في اتخاذ القرارات الإصلاحية، ويذكرون في عام 1945 طلب الأميركيون من الملك السعودي إلغاء العبودية في بلاده، فاستجابت المملكة بعد 18 عاماً.
سوريا تتهم الحريري والإخوان بـ «التآمر»
اتهمت سوريا أمس حركة «الإخوان المسلمين» السورية وتيار «المستقبل» في لبنان بالوقوف خلف «أعمال إرهابية» رافقت الاحتجاجات التي شهدتها مدن سورية عدة، منذ منتصف الشهر الماضي. وبعد طول حديث عن مؤامرة خارجية، أفرجت سوريا أمس عمّا عدّته «بداية مسلسل الوثائق والمعلومات» التي تشير إلى عناصر هذه المؤامرة. وأذاع التلفزيون السوري أمس شريطاً تضمّن ما وصفه بـ«اعترافات أفراد خلية إرهابية» قالوا إنه جرى تنظيمهم وتمويلهم وتسليحهم من النائب جمال الجراح للقيام بأعمال إرهابية في سوريا ودعم الأنشطة الاحتجاجية هناك. وقد تجاهلت الفضائيات العربية والدولية هذه المعلومات، فيما نفى تيار «المستقبل» في لبنان أي علاقة له بما يجري في سوريا. وقال النائب الجراح إن ما عرضه التلفزيون السوري هو «مسرحية بإخراج سيّئ»
«اعترافات سوريّة» تربط المحتجّين بـ«الإخوان» وجمال الـجرّاح
بثّ التلفزيون السوري أمس اعترافات لأشخاص قال إنهم ينتمون إلى «إحدى الخلايا الإرهابية المسلحة» التي «حرّضت على التظاهر»، أكدوا في خلالها أنهم تلقّوا دعماً من النائب عن كتلة «المستقبل» جaمال الجرّاح.
وعرض الشريط اعترافات لأنس كنج الذي وُصف بأنه رئيس الخلية، حيث أكد أنه «تلقّى الأموال والسلاح عبر الوسيط أحمد العودة، الذي كان مرسالاً بينه وبين النائب (اللبناني) جمال الجرّاح».
وقال كنج (من مواليد دمشق عام 1982) إن «العودة أكد له انتماءه إلى جماعة الإخوان المسلمين»، مضيفاً أنه «تمكن من تجنيد اثنين من أصدقائه هما محمد بدر القلم ومحمد السخنة لتنفيذ أوامر جاءتنا لتحريض الناس على التظاهر، وخصوصاً أمام الجامع الأموي» في دمشق. وتابع «ثم جاءتنا الأوامر بالتسلّح والقيام بعمليات تساند إخواننا في درعا وفي جميع المحافظات السورية، مثل بانياس واللاذقية».
وشرح كنج قائلاً: «أرسلت بدر مع 8 شباب إلى الجامع الأموي ليهتفوا بالحرية، فتجمع الناس وكانوا نحو 500 شخص، ثم جاءت دوريات الأمن فهرب بدر بحجة أنه مترجم أو دليل سياحي مع سائحتين أجنبيتين». وأضاف «قال لي عودة إنه يجب أن نطلق نحن النار على المتظاهرين والمسيرة والشبان الذين يؤيّدون الرئيس بشار الأسد».
وأكد كنج أن العودة «كان يقول لي إن هناك خلايا أخرى موجودة، وإنه يتعامل مع رؤسائها، والسلاح متوافر بكثرة عندهم، وكان يجلبه عن طريق لبنان بواسطة الرشى». وتابع أن العودة «كان يرسم لنا الهجمات بالحرف الواحد، ويقول لا تخرجوا عن هذا المجال حتى لا تحصل أي أخطاء»، مشدداً على ضرورة أن «نري العالم أن رجال الأمن هم الذين يقتلون الناس، ومساندة إخواننا في درعا وجميع المحافظات الأخرى».
كذلك عرض التلفزيون السوري مشاهد لأسلحة متنوعة ضبطت مع أفراد الخلية. وقال كنج إن عودة أبلغه أنه تمكن من تهريب الأسلحة عبر الحدود عن طريق دفع رشى لموظفين على الحدود. وأضاف «آخر مهمة كانت الهجوم على مخفر السبينة في ريف دمشق، على أساس أن يؤمّن لنا أحمد سيارة تشبه سيارات الأمن، وجلب لنا تلفونات متطورة جداً، وأوكلنا إلى شخص معين تصوير القتلى والجرحى وإرسال الصور مباشرة إلى موقع الثورة (فايسبوك)».
من جهته، أكد محمد بدر القلم لقاءه بالعودة الذي «قال إنه مستعد لأن يجلب لنا كل شيء، ويؤمّّن لنا سيارة، فأقودها على أنها سيارة أمنية»، على أن «يجري تصويرها عند تفجير المخفر، ونشرها على الفايسبوك لإيهام الناس بأن رجال الأمن هم من يقومون بالتخريب».
أما محمد أحمد السخنة، فأكد قيام كنج بالتخطيط «للهجوم على مخفر شرطة السبينة ليجرّد أفراده من السلاح». وأضاف أن «كنج كان يقول لنا إن الشهيد بيننا ستنال عائلته جائزة كبيرة جداً، وإذا عاش أحدنا أيضاً فسينال جائزة، وسيكون له راتب شهري».
وتحدث السخنة عن «جماعة خارجية» تمدّهم بالسلاح، وعن إمكان القيام بعمليات أخرى «بقدر ما يستطيعون تجنيد أشخاص ويحاولون إخراج الناس في تظاهرات تندّد بالأمن وبما يحدث في البلد».
وفي السياق، أشارت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إلى أنه «في ظل استمرار القوى الأمنية المختصة بالبحث عن المجموعات المسلحة التي قامت بعمليات القتل والإجرام في بانياس وضواحيها، وملاحقة أفرادها الذين اعتدوا على وحدة عسكرية كانت تتحرك على طريق عام طرطوس اللاذقية الاثنين الماضي، شهدت المدينة جريمة جديدة نفذها القتلة المجرمون قبل ظهر أول من أمس، حيث اعتدوا على القوى الأمنية وحاولوا قطع الطرقات العامة، وأطلقوا النار عشوائياً لترويع الناس، ما أدى إلى وفاة عدد من المدنيين الأبرياء من القوى الأمنية التي طلبت المساعدة من الجيش. وعلى الفور جرى التصدي للمجرمين القتلة، وأدّت المواجهة إلى استشهاد عنصر من الجيش وجرح اثنين، إضافة إلى جرح ستة من عناصر القوى الأمنية».
وتابعت «سانا» أنه «قتل ثلاثة من أفراد المجموعة المسلحة الإجرامية وأصيب ثمانية آخرون بجروح، وألقي القبض على عدد من المخربين والمشتبه فيهم لإحالتهم على العدالة، وجرى الاستيلاء على سيارة سياحية يستخدمها أربعة من المخربين».
وكان مصدر سوري رسمي قد نفى اتهامات وجّهت إلى السلطات السورية بمنع وصول الجرحى إلى المستشفى وإسعافهم، مؤكداً أنها «أخبار عارية من الصحة»، ومتهماً «مسلحين» بالقيام بذلك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن «بعض وسائل الإعلام والفضائيات تناقلت أخباراً عارية من الصحة»، مضيفاً أن «وزارة الداخلية وجدت أن من الضروري إيضاح أن 34 عنصراً من الشرطة أصيبوا بتاريخ 8 نيسان أمام مديرية الكهرباء في درعا بعيارات نارية، وكانت إصابة بعضهم خطرة».
وتابع المصدر أن هؤلاء المصابين «حاصرهم المسلحون الذين منعوا سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى لنقلهم إلى المستشفى»، ما أدى إلى «استشهاد أربعة عناصر نشرت أسماؤهم في الصحف والتلفزيون السوري». وأكد وجود «أوامر حازمة وجّهت إلى قوات الشرطة بعدم استخدام العيارات النارية ضد المتظاهرين، حتى لو أصيب» أفراد الشرطة.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أعلنت أن قوات الأمن السورية منعت الطواقم الطبية في مدينتين على الأقل من الوصول لمعالجة الجرحى من المتظاهرين.
في هذا الوقت، أعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا، رامي عبد الرحمن، أن آلاف النسوة اعتصمن على طريق عام بالقرب من مدينة بانياس الساحلية للمطالبة بإطلاق سراح مئات المعتقلين، وتضامناً مع المدينة المحاصرة». وأكد أن «أكثر من خمسة آلاف سيدة ينحدرن من قرية البيضا (ريف بانياس) والقرى المجاورة، اعتصمن على الطريق العام بين بانياس وطرطوس»، مضيفاً أن الاعتصام كان «للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين ألقي القبض عليهم أول من أمس، خلال الحملة الأمنية التي شنّتها القوات السورية في البلدة والقرى المجاورة، وتضامناً مع مدينة بانياس المحاصرة» منذ يومين.
ونفى عبد الرحمن الأنباء التي وردت عن «اعتقال (خطيب جامع الرحمن) أنس عيروط، أحد أبرز قادة الاحتجاجات في المدينة»، مضيفاً أن «أحد الشيوخ أكد للمرصد أن وفداً من القيادة سيأتي لزيارة المدينة والاستماع إلى مطالب الأهالي»، لافتاً إلى «نقص في المواد الغذائية نظراً إلى إغلاق المحال التجارية». وأكد أن الأمن «اعتقل بين 150 و200 شخص في قرية البيضا».
وللمرة الأولى، تظاهر نحو 500 طالب في كلية الآداب التابعة لجامعة حلب، للمطالبة بإطلاق الحريات. وذكر رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)، رديف مصطفى، أن «تظاهرة طالبية قامت في كلية الآداب التابعة لجامعة حلب شارك فيها 500 طالب تضامناً مع درعا وبانياس، وللمطالبة بإطلاق الحريات». وأضاف أن «قوات الأمن فرّقت المتظاهرين»، مشيراً إلى أن «الأمن اشتبك مع الطلاب بالأيدي واعتقل أربعة أشخاص». وأشار إلى أن «قوات الأمن أغلقت الأبواب المؤدية إلى الكلية ومنعت الدخول أو الخروج عبرها».
وفي دمشق، أكد رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، أن «نحو خمسين طالباً تظاهروا في كلية الحقوق التابعة لجامعة دمشق، هاتفين بشعارات تنادي بالحرية». وأضاف أن «قوات الأمن فرّقتهم بالقوة»، لافتاً إلى أن قوات الأمن «استخدمت العنف وضربت المشاركين بالهراوات». وأشار إلى «حدوث اعتقالات في صفوف المشاركين، ولكن لا يعرف عددهم بالتحديد».
إلى ذلك، أعلنت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن شهوداً عيان قالوا إن «قوات الأمن السورية قتلت جنوداً بعدما رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين في مدينة بانياس». وقالت إن مراقبي حقوق الإنسان «سمّوا المجنّد مراد حجو من قرية مضايا كأحد الجنود الذين قتلهم قناصة الأمن، فيما أعلن مراقب حقوق الإنسان وسيم طريف أن عائلة حجو وبلدته أكدتا أنه قُتل لرفضه إطلاق النار على الناس».
وأضافت الصحيفة أن شريط فيديو على موقع «يوتيوب» أظهر جندياً سورياً جريحاً وهو يقول إنه أُصيب بعيارات نارية في ظهره على أيدي قوات الأمن، بينما عرض شريط فيديو آخر جنازة محمد عوض قنبر الذي تقول مصادر إنه «قُتل لرفضه إطلاق النار على المتظاهرين».
«العالم» ومغازلة المشاهد العربي
رغم أنّها نقلت الثورات المتنقلة في العالم العربي، قوبلت تغطية قناة «العالم» الإيرانية، لأحداث البحرين باتهامات التسييس، ولا سيما من الجانب البحريني. فالتظاهرات في هذا البلد الخليجي، التي جرى التعتيم عليها على معظم الفضائيات، تابعتها «العالم» بتغطية مكثفة، ما فُسّر على أنّه اهتمام بخلفيات سياسية ومذهبية. يمكن أن يقال الكثير عن دور الفضائية الناطقة باللغة العربية التي تتبع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني (IRIB)، الخاضعة بدورها لإشراف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية. فقد جاء إطلاقها عام 2003، في لحظة سياسية حساسة، عشية سقوط نظام صدام حسين (العدو اللدود لإيران)، ودخول الاحتلال الأميركي للعراق. كان بثها في البداية، موجهاً نحو المشاهد العراقي، قبل أن تطل على الجمهور العربي عامة. يرى الباحث الفرنسي «مايكل براه» في دراسة له عن القناة «أنّ إنشاء قناة العالم ينبع من إرادة طهران التعبير عن الأحداث، من خلال رؤية منسجمة مع التفسيرات التي تقدمها للتطورات الإقليمية والعالمية».
ويضيف إنّ «العالم» هي «أداة للدعاية السياسية، تُستخدم أساساً بهدف حشد الرأي العام العربي حول الرؤية الإيرانية من مختلف التطورات».
في خطاب «العالم» ما يؤكد هذه الفكرة. فهي، مستندة الى وجود رأي عام عربي ساخط على السياسات الأميركية، لا توفر جهداً لإظهار مخاطر التدخل الغربي في شؤون المنطقة، وضرورة مواجهته عبر وحدة الموقف. يتضح ذلك جلياً عند كلّ عدوان إسرائيلي يقع على لبنان، أو في ممارسات الاحتلال الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة. حينها، تلبس القناة عباءة «الإعلام المقاوم» المندد بالاحتلال، الذي عرفنا نموذجه عبر قناة المنار اللبنانية، التابعة لحزب الله. انسجاماً مع هذا الموقف، لا تستضيف القناة شخصيات إسرائيلية، ولا تلزم نفسها تقديم «الرأي الآخر» الإسرائيلي، حتى لو انتدبت مراسلاً لها من داخل القدس الشرقية (اعتقلت قوات الاحتلال مراسل القناة في القدس المحتلة خضر شاهين، بتهمة التخابر مع دولة «عدوة» وجرت محاكمته). ورغم أنّها تفتح الهواء لأصوات مدافعة عن السياسات الأميركية، تحرص على استبعاد شخصيات أميركية تحمل صفة رسمية حالية. يسجل للقناة أيضاً، أنّه رغم العلاقة التي تربط طهران بحركة حماس الفلسطينية، وببعض أطراف المعارضة اللبنانية، تفتح شاشتها لأصوات توجه اتهاماتها إلى إيران وسوريا بالتدخل في الشأنين اللبناني والفلسطيني.
العالم هي واحدة من القنوات الأجنبية التي تخاطب العالم العربي مثل «الحُرة»، «فرانس 24»، «بي بي سي»، «التركية»، «أورونيوز»، «روسيا اليوم»… وهي جميعاً لم تتمكن من حجز حضور لافت لها لدى المشاهد العربي، الذي ظلّ وفياً لقنواته العربية النشأة، لكن ما يميز «العالم» عن باقي تلك القنوات أنّها تركن الى هوية «إسلامية» تجمعها بجمهور ذي غالبية مسلمة (جميع مذيعاتها، على سبيل المثال، يرتدين الحجاب الإسلامي). قد تمثّل هذه الهوية المشتركة عامل ثقة وإقناع، ولا سيما حينما يجري التعرض لقضايا تهمّ جميع المسلمين، من الرسوم الكاريكاتورية الى حرق القرآن الكريم على يد قسّ أميركي متطرف. ورغم حرص القناة على التمسك بهذه الهوية الجامعة دون إظهار أصولها «الشيعية»، سرعان ما تُواجه بها مع كلّ احتكاك سياسي يأخذ طابعاً مذهبياً: بدءاً من النزاع في العراق، الى حرب صعدة في اليمن، والخلافات السعودية ـــــ الإيرانية، وصولاً الى تغطيتها الحالية للثورة البحرينية. يتجلى هذا التوتر المذهبي في برامج الاتصالات المباشرة، إذ تتلقى القناة شتائم تطاول المسلمين الشيعة على خلفية تغطيتها لبعض الثورات واتهامها ببث الفرقة والتحريض. لعل اللافت، أنّه في تغطيتها للثورات التي تتحرك في العالم العربي، اختارت «العالم» أن تصف ما يجري بأنّه «صحوة إسلامية». هي اختارت للثورات توصيفاً ذا بُعد إسلامي، فالقناة الواعية لهويتها غير العربية وإن تكلمت «بالعربي»، تبحث في الدين عن رابط يشدها الى جمهور عربي بات البعض منه يتوجس من القادم من بلاد فارس.
منذ انطلاقة الشرارة الأولى لتحركات الشارع العربي، حضرت القناة كمثيلاتها من الفضائيات الإخبارية. هكذا، تابعت سقوط نظامي زين العابدين بن علي وحسني مبارك، رغم تواضع إمكاناتها اللوجستية. كان للحراك المصري حصته الواسعة من التغطية التي يمكن النظر اليها وتقويمها ضمن الأداء المهني العام، لكن المتابع لا يمكنه أن يغفل عن خلفياته السياسية، ولا سيما أنّ القناة عرفت علاقة لطالما اتسمت بالحساسية مع نظام مبارك. فقد سبق لسلطات الأمن المصرية أن أغلقت مكاتب القناة في 2008، بدعوى عدم حصولها على تصريح بالبث من مصر، لكن استياء القاهرة حينها، يعود، في الواقع، الى بث طهران فيلماً وثائقياً عن الرئيس المصري الراحل أنور السادات، واتهام قناة العالم بالاشتراك في تمويل الفيلم الذي يسيء، بحسب النظام المصري، إلى السادات، وهو ما نفته القناة. بعد عام، أوقفت إدارة قمر «النايل سات» بث القناة على تردداتها، ومثلها فعلت إدارة قمر «العرب سات». فُسّر حجب صورة القناة عن القمرين العربيين بأنّه ترجمة لتأزم علاقات طهران بكلّ من القاهرة والرياض، ولاستياء الأخيرتين من دور القناة الإعلامي المفترض كصوت إيراني داخل العالم العربي. فقد كان ثمة تركيز واضح من «العالم» على قضايا لطالما مثّلت استفزازاً للنظام المصري السابق، كتناول قضية «التوريث» أو مسألة العلاقات المصرية ـــــ الإسرائيلية، وما يمكن أن يساق فيها من اتهامات للقاهرة بالتخلي عن دورها العروبي، لمصلحة حماية المصالح الإسرائيلية والأميركية.
مع اندلاع الثورة المصرية حشدت القناة الإيرانية كلّ فضائها لمواكبة التحول السياسي في مصر، من خلال تغطية مباشرة ومستمرة تنقل نبض الشارع «بحماسة» لا تقل عن «حماسة» قناة الجزيرة. بالطبع لا مجال هنا لإجراء مقارنة بين التغطية الإعلامية للمحطتين، فالجزيرة تبقى القناة الفضائية العربية الأكثر مشاهدة لدى الجمهور العربي، بل يذهب البعض إلى اعتبارها أكثر من مجرد ناقلة للحدث، إلى كونها مشاركة في صنعه، لكن الجزيرة ستُغيّب ثورة أخرى عن شاشتها، نعني بها التظاهرات البحرينية التي لن تجد لها مساحة في الفضاء الإعلامي. ثمة اتهام للقناة القطرية بالخضوع لحسابات سياسية خليجية وقطرية، تفرض عليها التعامل بهذا القدر من «اللامبالاة» مع ثورة تُراق فيها الدماء ولا تقل شعاراتها أحقية عما رفع في مختلف الشوارع العربية. في كتابها «قراءة في ثقافة الفضائيات العربية، الوقوف على تخوم التفكيك»، تتحدث الدكتورة نهوند القادري عيسى عن مفارقة العلاقات الملتبسة للفضائيات العربية مع الأنظمة الحاكمة التي تمتلك هذه الفضائيات، فتقول إنّ «المواقف التي تضطر هذه المحطات إلى اتخاذها لأسباب سياسية، تأتي أحياناً بطريقة لا تتوافق مع مهنية العمل الإعلامي الذي يتطلب حداً أدنى من الحيادية، ويتطلب تأمين شيء من التوازن بين مختلف الأطراف، يحترم عقل المشاهد». تأسيساً على ما تقدّم، يمكن تفسير صمت الفضائيات العربية عما يجري في البحرين، فتداخل المصالح السياسية يفرض على هذه الفضائيات، التي تملكها أصلاً الأنظمة الحاكمة الالتزام بأجندات بلادها، لكن هذا التغييب المقصود للمسألة البحرينية عن المشهد الإعلامي العربي العام، سيقابَل بتغطية مكثفة من «العالم» الإيرانية، التي واكبت ولا تزال، الحدث البحريني، محاولةً تكوين وعي جماعي حول ما يجري في المملكة الصغيرة.
لا يمكن بأيّ حال إنكار أنّ ما تقوم به «العالم» يدخل في إطار ممارسة الوسيلة الإعلامية دورها المهني بنقل الحقائق وإعلام الجمهور، وهي نقطة تسجل لمصلحتها من دون أن تعفيها من النقاش بشأن «التعاطف هنا» و«التغاضي هناك»، تحديداً في سوريا، حيث خطاب «العالم» لم يتجاوز وجهة نظر النظام السوري للأحداث (تقليل من أهمية التظاهرات المعارضة وحديث عن مندسين…). هو نقاش تُواجَه به، ليس فقط «العالم»، بل معظم الفضائيات، التي بدا أنّها «تحتفي» بالثورات، بحسب ما تمليه عليها مصالح بلادها، أو بحسب ما تراه «نظاراتها»، إذا ما استعرنا تشبيه الباحث الفرنسي «بيار بورديو». ففي نقده اللاذع للتلفزيون، يقول بورديو إنّ «للصحافيين نظارات خاصة يرون من خلالها أحداثاً ما، ولا يرون أخرى، ويروون بطريقة معينة الأشياء التي يرونها». ويذهب مواطنه الباحث باتريك شارودو الى تسمية الصحافيين بأنّهم «آلة للإعلام» (Machine à informer)، فهم ينتقون من الأحداث، ومن ثم يشكلون ما سبق أن جرى انتقاؤه ليخرج الى الفضاء العام. لا تأتي الانتقائية التي تمارسها وسائل الإعلام من باب الصدفة، ولو اختلفت «النوايا». وفي تغطية «العالم» لأحداث البحرين، قد يقال الكثير عن خلفيات متابعتها لهذا الملف وربطها بأسباب مذهبية، وهو أمر قابل للنقاش بالطبع، لكن ما هو غير جائز إنكار حق أيّ مؤسسة إعلامية في تغطية حدث ما. إنّ الاتهامات بممارسة التحريض والمبالغة في نقل الوقائع التي تطلق ضد «العالم»، لم تثبت صحتها من عدمها، فالصورة التي تنقلها القناة عن البحرين تكاد تكون هي الاسثناء الوحيد، في ظلّ غياب باقي الفضائيات العربية الممتنعة عن الخوض في الحراك البحريني. لقد اتهم التلفزيون البحريني الرسمي «العالم» صراحة بالتحريض، وذهبت الجمعية العربية للصحافة وحرية الإعلام، «ارابرس» (التي تتخذ من لندن مقراً لها) إلى تصنيف القناة على أنّها معادية للعرب، وأنّها تعمل على ضرب الوحدة العربية وشقها، وذلك للدور الذي تقوم به في تغطية التحركات في البحرين والسعودية، واصفة أداءها بأنّه تحريض طائفي. لا شك أنّه في مقاربتها للوضع البحريني، تنطلق «العالم» من موقف سياسي يظهر جلياً، ولا سيما في مفرداتها المستخدمة، من تسمية القوات السعودية في درع الجزيرة بأنّها قوات «احتلال» الى تشديدها على الخليج «الفارسي». هذا الموقف، على وضوحه، ليس لحظوياً بل هو امتداد لتأرجح العلاقات الإيرانية ـــــ السعودية التي تترجم على فضائيتي البلدين. فمقابل اهتمام «العربية» بحراك المعارضة الإيرانية، تتصدى «العالم» للشأن السعودي بمختلف تفاصيله، كأن تخصّص برامج حوارية للحديث عن سيول جدة أو عن الوهابية أو عن مصير المملكة بعد مرض الملك! ويصل «الكباش» الإعلامي الى مستوياته العليا خلال تغطية حرب صعدة، إذ أفردت «العالم» مساحة واسعة لإيصال صوت الحوثيين. أما التظاهرات التي شهدتها بعض مدن السعودية، فكان لا بد أن تلقى متابعة خاصة بدورها من القناة، الى جانب إيلائها بالطبع الشأن البحريني أولوية في التغطية. هذه التغطية التي لاقت اعتراض البعض، ورضى البعض الآخر، لا يمكن الحكم على مدى نجاحها في تحويل تظاهرات البحرين الى قضية تحجز لها مكاناً في الفضاء العربي العام. فتلاقي الهوية الفارسية الشيعية لقناة «العالم» مع معارضة بحرينية تنتمي بغالبيتها إلى المذهب الشيعي، إضافةً الى تخلي الفضائيات العربية الأكثر مشاهدة عن متابعة الوضع البحريني، كلّها عوامل لم تكن في مصلحة ثوّار البحرين، الذين خسروا فرصتهم في تكرار التجربة المصرية والتونسية. فالتلفزيون، كما قال عنه بورديو، «أصبح الحَكم للوصول الى الوجود السياسي والاجتماعي».
تطْييف المجازر: فلوجتُنا وحلبجتكم!
يثير السجال الذي اندلع أخيراً داخل الطبقة السياسية العراقية بسبب مجزرة حلبجة الكثير من علامات الاستفهام الكبيرة. تطاول علامات الاستفهام تلكْ المغزى الحقيقي لبعض المطالبات وللعملية البرلمانية المكرِّسة للمحاصصة الطائفية والناتجة منها، إذ امتنع فريق من الساسة ـــــ معظمهم من قائمة «العراقية» التي يقودها إياد علاوي المُعَرَّفُ عنه في الصحافة الغربية كعلماني شيعي ـــــ عن اعتبار مجزرة «حلبجة»، التي ارتكبها نظام صدام حسين في آذار 1988وراح ضحيتها أكثر من خمسة آلاف مدني كردي قتلوا بالغازات السامة، جريمة إبادة جماعية. وطالب هؤلاء باعتبار تدمير مدينة الفلوجة، وارتكاب المجازر فيها مرتين، من جانب قوات الاحتلال والحكومة التي كان يرأسها آنذاك علاوي ذاته في 2004، جريمة إبادة جماعية. رفضت الزعامات السياسية الكردية هذا المطلب، ووافقت قيادات مهمة في تحالف المالكي عليه، وحصر الموضوع بالتحقيق مع علاوي شخصياً.
مفهومٌ أنَّ قرارات أو أحكاماً باعتبار هذا الحدث أو ذاك «جريمة إبادة جماعية» هي أمر قضائي بالدرجة الأولى. بمعنى، أنّه ليس إجراءً برلمانياً تشريعياً، إلا لناحية رمزيته ومناقبيته، لكنّنا حتى لو غضضنا الطرف عن هذا الاعتبار، ووافقنا على إصدار قرار مماثل مباشرةً من المؤسسة التشريعية، فإنّنا لن نجد له أيّ تجسيد عملي في الواقع السياسي، اللهمّ إلا لجهة إصدار بعض قرارات التعويض للضحايا الذين لا يزالون على قيد الحياة، أو لذوي القتلى منهم.
لم يكن لائقاً ولا إنسانياً، أن تبادر بعض الأطراف في كتلة «العراقية» إلى رفض هذا القرار، أو إلى ممارسة شكل من الابتزاز السياسي والعاطفي، عبر المطالبة باعتبار أحداث مدينة الفلوجة جريمة إبادة جماعية هي الأخرى، كمقابل للقرار السالف. كم كان الأمر سيبدو طبيعياً ومشروعاً، لو أنَّ تلك الأطراف استجابت للمسعى العام ووافقت على هذا القرار، إنصافاً لضحايا «حلبجة» الأبرياء، ثم، بعد فترة زمنية معقولة، بادرت وطرحت مطلبها الخاص بمجازر الفلوجة أو سواها.
لقد ورطتْ هذه الجهاتُ في «العراقية» زعيمها علاوي من حيث لم تشأ ـــــ هذا إذا أسقطنا مسبقاً من الحساب فرضية التآمر المسبق عليه داخل كتلته البرلمانية التي وجدت مَن يروج لها ـــــ وجعلته هو المطلوب الأول للتحقيق الداخلي أو الدولي، في حال الموافقة تشريعياً على هذا المطلب، وهذا ما تأكد فعلاً بعد حين. سارع مقربون من المالكي إلى تأييد المطلب الخاص بالفلوجة، ودعوا إلى بدء التحقيق مع علاوي، بوصفه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة آنذاك، دون الإشارة إلى مسؤولية قوات الاحتلال التي كانت صاحبة السيادة الفعلية على الأرض. ثم التحق بهم عدد من شيوخ العشائر العربية السنية في تحالف «الإنقاذ» في محافظة الأنبار، التي يتبع قضاء الفلوجة لها إدارياً. وهؤلاء، على خلاف سياسي عميق مع قائمة علاوي وحلفائه في المحافظة. وحين شعر علاوي والمقربون منه بجدية هذه المطالبات وخطورتها، أطلقوا تهديداً جديداً بوجه المالكي، مفاده أنّهم مستعدون للذهاب إلى التحقيق بخصوص ما حدث في الفلوجة، لكنّهم سيطالبون ـــــ وهنا يتكرر الابتزاز بصورة أكثر وضوحاً ـــــ بفتح تحقيق آخر بخصوص مجزرة «الزركة». هذه الأخيرة حدثت في عهد المالكي، حين وجهت قواته الأمنية ضربة قاسية ودموية في 2007 إلى تجمعات حركة «جند السماء» في منطقة «الزركة» قرب النجف. وقد قدرت بعض المصادر عدد القتلى في تلك الصدامات بأكثر من ألف شخص، قضوا خلال ساعات قليلة. و«جند السماء» حركة مهدوية شيعية مناوئة للحكم وللمرجعية الشيعية النجفية، قالت قيادتها إنّ أنصارها لم يكونوا مسلحين يوم ذاك إلا على نحو رمزي، وللدفاع عن النفس في بلد يعج بالميليشيات والمسلحين، وإنَّ نشاطاتهم كانت دعوية وسلمية، وإنَّ معظم القتلى كانوا من أطفال ونساء أسر الأنصار المجتمعين في مخيمات مدنية هناك.
بقليل من التمعّن، وباستعادة البواعث الحقيقية «المفترضة» لقرارات ومطالبات كهذه، يمكن تلخيصها بإنصاف الضحايا وإعادة الاعتبار إليهم وإدانة جلاديهم، نجد أنفسنا إزاء الواقع الفعلي المعاكس، إذ لم يكن الداعون إلى اعتبار مجزرة «حلبجة» أو الأنفال أو انتفاضة ربيع 1991 المعروفة باسم «الانتفاضة الشعبانية» أو «مجزرة تجار بغداد» أو غير ذلك من جرائم النظام السابق، متسقين مع النهج الإنساني والوطني اللازم والمفترض قدر اتساقهم مع بواعث أخرى، قد لا تخرج عن إطار الثأر السياسي وإحراج خصوم الأمس الطائفيين، وتسجيل نقاط ثمينة في سجلات الصراع اليومي.
في المقابل، لم يكن الداعون إلى اعتبار الفلوجة ميدان جريمة إبادة جماعية مبدئيين وصادقين ومتسقين مع أي نهج أو فهم وطني وإنساني ينحاز إلى الضحايا الأبرياء ضد جلاديهم، لأنّهم سكتوا طويلاً على تلك المجازر، كما أنّ هؤلاء لم يكونوا بهذه الصفات حين رفضوا القرار الخاص بحلبجة، أو حين اشترطوا ربطه بقرار مشابه بخصوص مجزرتي «الفلوجة» أو «الزركة».
بالمثل، وبنظرة استقرائية بسيطة، نجد أنّ المقربين من المالكي، الذين وافقوا على المطلب الخاص بالفلوجة، لم يكونوا مبدئيين ومتسقين مع أي نهج وطني أو إنساني، بعدما سكتوا بدورهم طويلاً على هذا الموضوع، واكتفوا دائماً بتحميل مقاتلي تنظيم القاعدة التكفيري مسؤولية ما حدث لأهالي الفلوجة، بل هم أرادوا بهذه الموافقة، إزاحة خصمهم السياسي المدعوم سعودياً ـــــ علاوي ـــــ وإخراجه من الساحة نهائياً، بعدما نجحوا في تهميشه وسحب بساط «مجلس السياسات العليا» الذي وعِدَ به من تحت قدميه، وخصوصاً بعدما تشرذمت قائمته، وأصبح مجرداً من هيلمان القائد الضد.
بصراحة قد تزعج البعض، يمكن المراقبين الاستنتاج أنَّ هذه الأطراف جميعاً ـــــ الأحزاب الكردية والإسلامية الشيعية في تحالف المالكي والمكونات العربية السنية في قائمة علاوي وغيرها ـــــ كانت تمارس نوعاً من المناكفات والصراعات الفئوية النابعة من انحيازات وولاءات طائفية خارج إطار الانحياز الإنساني إلى ضحايا المجازر وتحكيم القانون، وربما ضده، وهي تستخدم جثث ودماء الضحايا لحساباتها الحزبية الخاصة.
لقد سارعت جهات أخرى، مشاركة في العملية السياسية، إلى التنبيه من خطورة فتح «ملف المجازر». فحزب المجلس الأعلى بقيادة الحكيم، حذر من الاستمرار في هذا النوع من المناكفات، وقال صراحة إنّ آفاق التنافس والتصعيد بهذا الخصوص خطيرة، وقد ينتج منها ما لا تحمد عقباه. والواقع، فهذا أمر مفروغ منه، وربما لم يكن الدافع إليه الحكمة البالغة أو الاستشراف الاستراتيجي لدى قيادة حزب الحكيم، بل هو الخوف من تداعيات فتح هذا الملف عملياً على وضع العملية السياسية الذي قد يدفع الاحتلال الأميركي، المتضرر الأكبر منه، إلى التحرك العنيف ضد جميع اللاعبين بنار المجازر. توقعات حزب الحكيم من أنَّ هذه المناكفات ستنتهي إلى تهدئة محسوبة وستتلاشى تدريجياً، يبدو أنّها أقرب إلى الواقع. فقد بدأت الضجة تخفت رويداً رويداً. هذا يؤكد أنَّ جميع الأطراف المشاركة اليوم في العملية السياسية ستكون متضررة من فتح هذا الملف، فهي تتحمل المسؤولية عن كل ما حدث في العراق المحتل منذ 2003 حتى الآن، وأنَّ من الخير لها أنْ تغلقه بأسرع ما يمكن. هذه «النصحية الثمينة» من حزب الحكيم لشركائه تؤكد لنا أنَّ تَطْييف المجازر أمر خطير ومرعب، وأنَّ المحتل الذي سكت حتى الآن، ولم يقل كلمته في الموضوع، قد يتحرك إذا ما أصبحت رؤوس قادته السياسيين والعسكريين مطلوبة من جانب محكمة دولية.
ليس لدى الاحتلال ما يخسره من مناكفات الساسة الطائفيين العادية، بل هو كان يشجعها في أوقات أخرى، لكنّه سيخسر كل شيء إنْ وضِعَ موضع المتهم بارتكاب «إبادات جماعية». هذا يعني أنّ الملف الأكبر والأخطر، ألا وهو ملف «مجزرة احتلال العراق»، وضحاياه المليون، سيبقى مغلقاً في الوقت الحاضر. أما إذا تجرأ أحد على فتحه الآن، فلن يكون صمت الاحتلال على المشاغبات السياسية لـ«أولاد الطوائف»، الذين جعل منهم حكاماً، وارداً البتة.
إشكاليات إسقاط النظام الطائفي
يستثير التحرّك الشبابي من أجل «إسقاط النظام الطائفي» جملة من الإشكاليات والأسئلة والنقاشات والمواقف، وخصوصاً بعد محطته البيروتية يوم الأحد الماضي. بدءاً، ينبغي التأكيد أنّ البعض قد حاول ركوب موجة التحرّك. وهو فعل ذلك في امتداد مناورات ذات أهداف «خاصة» و«عامة»، «داخلية» و«خارجية». ولا يقع في مقدّمة هذه الأهداف، بالطبع، السعي إلى إلغاء الطائفية السياسية، بل ممارسة ضغوط أو التفتيش عن مخارج لأوضاع وتوازنات، لم تعد ملائمة كما كان الأمر في السابق.
ورغم ذلك، وفي حالة رئيس المجلس النيابي تحديداً، يمكن إخضاع الشق المناور في موقفه، لعملية اختبار وضغط تفضي إلى أحد أمرين: إما كشف حقيقة الموقف، أو الدفع باتجاه بحث خطوات تشريعية لمصلحة البنود الإصلاحية في «اتفاق الطائف»، ومن ثمّ في الدستور اللبناني.
ثمّ يجب أيضاً التنبّه إلى عملية أخطر، وهي محاولات التشكيك التي يطلقها البعض ضدّ التحرّك بوصفه أنّه، في النهاية، تحرّك طائفي هو الآخر. يجادل هؤلاء من زاوية أنّ فئة من اللبنانيين، هي فئة الطوائف المسيحية تحديداً، تعاني اختلالاً ديموغرافياً، وتوفّر لها «المناصفة»، ما يحول دون المزيد من خسائرها اليوم، وتهميشها مستقبلاً. وهم لذلك، يرون أنّ كلّ حديث عن إلغاء الطائفية السياسية، مسعى «خبيث» يصبّ في مصلحة حصّة الطوائف الإسلامية الآخذة نسبها العديدة في الازدياد، عاماً بعد عام.
ويدفع فريق من هؤلاء، وبما يشبه التذاكي، هذه المعادلة إلى حدّها الأقصى: تريدون إلغاء الطائفية السياسية؟ نحن نريد العلمنة الكاملة! طبعاً هم لا يريدون هذه أو تلك، إنّما يقولون ذلك لسببين: أوّلاً لاتهام كلّ دعوة إلى إلغاء الطائفية بأنّها طائفية هي الأخرى. ثانياً، للردّ بمطلب يرونه مرفوضاً سلفاً من ممثلي الطوائف الإسلامية، أيّ بما يبقي الأمور على حالها الراهنة، مع تحميل المسؤولية للخصم عن استمرار نظام متخلّف بكلّ ما في الكلمة من معنى.
هذا موقف مكشوف الأهداف. وهو في مبرّراته ساقط في أمرين، سبق أن أشار إليهما خصوصاً، المطران المتحرّر والإصلاحي غريغوار حداد. فهو لفت إلى أنّ «المناصفة» لا تلبّي العدالة، ولا توفّر ضمانة لأحد (وهو لهذا الأمر «استحق» اعتداءً سافراً ومجرماً من أحد «المجانين» قبل مدّة ليست
بعيدة!).
يقتضي المنطق الحريص والإصلاحي (الثوري في ظروف لبنان) اعتماد التدرّج في عملية إسقاط النظام الطائفي. ولذلك رفعت الحركة الديموقراطية التقدّمية في لبنان شعار «إلغاء الطائفية السياسية» (برنامج الحركة الوطنية المرحلي للإصلاح السياسي)، وإقرار «قانون مدني اختياري للأحوال الشخصية». وهي بذلك وبوضوح كامل، قد اختارت، مرحلياً، شعار الدولة المدنية التي تحرّر السلطتين، السياسية والإدارية، من الطائفية، دون أن تلغي دور المؤسسات الأهلية سواء منها الدينية أو المدنية.
وفي المقابل، لا يعترف النظام العلماني المعمول به في عدد من البلدان الأوروبية إلا بدور الفرد دون أيّ دور للجماعات (ليس الأمر كذلك في المملكة المتحدة التي لا تزال تعمل بتقليد الملكية الدستورية).
إنّ النضال تحت شعار إقامة الدولة المدنية هو المناسب، قطعاً، في لبنان، في هذه المرحلة التاريخية. وكلّ جنوح نحو المطالبة بالعلمنة الشاملة والفورية، إنّما هو مبالغة ستؤدّي عن قصد أو عن غير قصد، من جانب القائلين بها، إلى محاصرة قوى التغيير وجعل مهمّتها أعقد وأصعب وأطول. وكنا في مقالة سابقة قد أشرنا إلى بندين تنفيذيين كهدفين مباشرين لاختراق النظام السياسي القائم، وهما قانون الانتخاب وقانون الأحوال الشخصية.
لا يعني ذلك منع المطالبين بدولة علمانية من أن يكون لهم دورهم وحضورهم في التحرّك وفي مجرياته كافة، لكنّ هذا التحديد يمليه السعي من أجل اختيار الشعارات والمطالب المناسبة في هذه المرحلة من تطوّر الوضع اللبناني، وبما يوفّر للتحرّك فرصاً أكبر وأسرع في تحقيق أهدافه. ولا بأس من أن نشير في امتداد هذا الأمر، إلى أنّ الدستور اللبناني، قد نصّ على إنشاء «مجلس شيوخ» على أساس طائفي. وهو مجلس يهتمّ بأمور عامة «مصيرية»، بينما يجري تحرير كلّ السلطات اللبنانية من الانقسام الطائفي والمذهبي: السلطات السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية.
وكذلك يجب تكرار أنّه بسبب أنّ النظام السياسي الطائفي اللبناني منظومة متكاملة من المؤسسات والعلاقات والنشاطات، فمن الضروري تعبئة كلّ المتضرّرين، في الحراك الراهن تحت شعار إسقاط هذا النظام، وخصوصاً الشباب والشابات منهم.
ويقود هذا الأمر إلى مسألة لا بدّ من نقاشها ولو بخطوطها العامة، وهي مسألة قيادة التحرّك، ومسألة توسيع المشاركة فيه: السياسية والشعبية على حدّ سواء. اكتسب التحرّك الراهن زخمه وجاذبيته بسبب عفوية القوى الشبابية التي أطلقته تأثّراً بالحراك العربي وبالأزمات المتفاقمة، لكنّ هذه العفوية تحتاج إلى نضج قيادي، من سماته وضوح الأهداف كما ذكرنا (دون قمع أو مجافاة التطلعات الجذرية…)، وتطوّر صيغ وآليات العمل والتفاعل، دون فئوية، أو في المقابل، دون إغراق وانفلاشية.
وتشير المعطيات المتوافرة، وخصوصاً بعد تراجع المشاركة في تظاهرة 10 نيسان، قياساً على سابقتها في 20 من الشهر الماضي، إلى أنّ بعض النقاش يراوح في النطاق نفسه، ولم يتعدّه إلى متطلبات توسيع المشاركة السياسية في التحرّك.
ستبقى بالتأكيد المشاركة الشعبية، في تظاهرة الشارع هي الأساس، لكنّ السعي إلى توفير دعم سياسي من جانب المهتمّين: من شخصيات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني… هو أمر في غاية الأهمية أيضاً. إنّ عقد لقاءات مركزية ومناطقية لهذا الغرض، هو أمر في غاية الأهمية، ومن شأنه، بالفعل، أن يبلور الخيار غير الطائفي الجديد الضاغط على الاستقطابين القائمين، وخصوصاً على القواعد الشعبية الأكثر تهميشاً والأكثر تضرّراً من النظام القائم، فضلاً عن النخب المتنوّعة التي تتطلّع إلى إقامة نظام مساواة ومؤسسات وعدالة وتنمية في
لبنان.
وفي امتداد توسيع التحرّك وتنويعه، ينبغي العمل أيضاً على تعميق الوعي بأهدافه وبشعاراته، في عملية ربط مستمرّة ما بين أزمات لبنان واللبنانيين المتعدّدة والمتفاقمة والمتعاظمة، والنظام السياسي الطائفي الراهن.
ومن البديهي أنّه، في سياق توسيع التحرّك وتوحيد أهدافه وتنويع قواه السياسية والاجتماعية والمدنية المشاركة، يمكن تصوّر تحوّلات طبيعية في قيادته بما يعكس المشاركة ويعزّزها في مستوياتها كافة. ويصبح عقد مؤتمر وطني أو أكثر، وعلى نحو منسّق مع آلية تحرّك متكاملة، احتمالاً ضرورياً لإضفاء مزيد من الصفة العامة والشاملة والوطنية، على التحرّك.
بديهي أنّه يترتب على الأحزاب والشخصيات اللاطائفية والمواقع دور مهم في تنسيق تعاونها، بما يرفد التحرّك بعناصر الدعم والمشاركة، دون السعي إلى تحقيق أيّ مكاسب فئوية، صغيرة كانت أم كبيرة.
ويبقى النقاش مفتوحاً، من أجل التخلّص من نظام الطائفية السياسية، وإنقاذ لبنان واللبنانيين من أزماته المتنوّعة